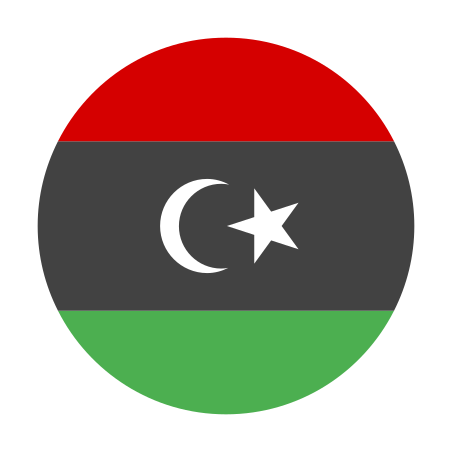المرحلة البحثية الثانية: الحكم الوطني
استغرقت مرحلة بحث شاغل الحكم الوطني الفترة الممتدة من 16 أكتوبر 2018 إلى 15 أبريل 2019، وركزت على دراسة التحديات ذات العلاقة ببناء الدولة والتحول الديمقراطي في ليبيا، ودور القانون في مواجهتها.
| Project Manager | سليمان إبراهيم |
| Main project | دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا |
ملخص تقرير شاغل الحكم الوطني
يرصد هذا التقرير التحديات ذات العلاقة ببناء الدولة والتحول الديمقراطي في ليبيا، ودور القانون في مواجهتها، فيحدد أهم القضايا الخلافية ذات العلاقة، ثم ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺎت التشريعية اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ: الظروف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت أثناءها، وفرص تطبيقها، وتقويمها. وينتهي التقرير برؤية للحكم الوطني وبناء الدولة، ومقترحات وسياسات تكفل ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي.
يتقصى شاغل الحكم الوطني تحديات بناء الدولة الليبية في أبعاد متمايزة، وإن ظلت مترابطة، فيتناول تحدي الشرعية والتغلغل المتعلق ببعد مؤسسات الدولة، وتحدي المشاركة الذي يظهر في بعد العملية السياسية، وتحدي التوزيع المتعلق ببعد السياسة العامة، ويكشف عن تحدي العامل الخارجي في البعد الدولي. وينطلق التقرير من مقاربة مؤداها أن مواجهة التحديات المتعلقة بكل بعد رغم تفاوت طبيعتها، وما تثيره من خلاف ومواقف متباينة واستقطابات حول قضايا مفصلية، مسألة لازمة لبناء الدولة وخلق إطار صالح لتحقيق المصالحة الوطنية واستدامتها.
فيما يتعلق ببعد مؤسسات الدولة تقصى التقرير التحديات المتعلقة بالفراغ المؤسسي، وسوء أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية الانتقالية، والتشكيك في شرعية هذه المؤسسات. وكشف تحليل التحديات المتعلقة بهذا البعد عن وجود قضايا دستورية تشكلت بخصوصها مواقف متباينة وتعلقت أساسا بشكل الدولة (فيدرالي/موحد) ونوع نظام الحكم (ملكي/جمهوري، برلماني/رئاسي). وقضايا دستورية ترتبط بأداء مؤسسات الدولة والعلاقة بينها، وتتمحور حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقلالية السلطة القضائية. ولم يتناول التقرير القضايا الخلافية المتعلقة بالنظام الفيدرالي/نظام الحكم المحلي/النظام المركزي تناولا مفصلا، لأنها أوطد علاقة بشاغل اللامركزية (الحكم دون- الوطني)، الذي سيكون محلا للدراسة في الشاغل التالي. وحصر التقرير موقفين من نظام الحكم يدعو أحدهما إلى العودة إلى النظام الملكي في حين يدعو الآخر إلى تبني النظام الجمهوري. وتبين أن المنادين بالعودة للشرعية الدستورية الملكية اختلفوا في طبيعة العودة بين العودة للملكية كمرحلة انتقالية سبيلا لعودة الاستقرار والأمن، على أن يُجرى لاحقاً استفتاء حول نظام الحكم وشكله، ومن يدعو لعودة للنظام الملكي بصفة دائمة، ويرفض إجراء أي تعديلات على الدستور إلا وفقا لما ينص عليه الدستور الملكي، الذي يحظر تغيير نظام الحكم الملكي. غير أنهم اتفقوا على أن تكون العودة للنظام الملكي مرتبطة بدستور 1963، وبذلك هم يختلفون مع دعاة الفيدرالية الذين يشترطون العودة لدستور 1951. وعلى الرغم من عدم بروز تيار أو حراك مؤيد للنظام الجمهوري، أمكن استنتاج وجود تأييد أوسع لإقامة نظام جمهوري عبر الاستعانة باستطلاعات الرأي العام، ومجموعات التركيز، والمقابلات المعمقة، فضلا عن بيانات الأحزاب والتيارات السياسية.
أما فيما يتعلق بالاستجابات التشريعية، فقد ركز التقرير على كيفية استجابة الوثائق الدستورية كالإعلان الدستوري؛ ومخرجات الهيئة التأسيسية كمقترحات اللجان النوعية عام 2014، ومخرجات لجان العمل عام 2015، ومشاريع الدستور الصادرة في 2016 و2017؛ والاتفاق السياسي 2015، وتبين أن المشرع الليبي تبنى النظام الجمهوري أساسا للحكم، حيث لم يكن الخيار الملكي خيارا مطروحا بشكل جدي عند واضعي هذه الوثائق.
أما قضية نظام الحكم، برلماني أم رئاسي أم شبه رئاسي، فلم يتبين تبلور تيارات سياسية ذات مواقف واضحة سوى استجابات التيارين الفيدرالي والملكي التي تدعو للعودة لدستور الاستقلال الذي يتبنى النظام البرلماني. أما بالنسبة للاستجابات التشريعية ذات العلاقة فيكشف تحليل الوثائق الدستورية أنها لم تتبن أياً من أنظمة الحكم المذكورة، فقد صُمم الإعلان الدستوري المؤقت بطريقة تعكس هيمنة السلطة التشريعية، وأعتبر الحكومة مجرد جهاز تنفيذي تابع للمجلس التشريعي ومنفذ لقراراته. كما لم ينص على وجود رئيس تنفيذي بصلاحيات متوازنة مع صلاحيات السلطة التشريعية، أما مخرجات الهيئة التأسيسية والاتفاق السياسي فقد تبنت صيغا يصعب تصنيفها ضمن أي من أنواع نظم الحكم. أما فيما يتعلق بتحدي أداء مؤسسات الدولة والعلاقة بينها فقد تناول قضية الضوابط والتوازنات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فتتبع العلاقة بين السلطتين في الوثائق الدستورية، والتطبيق الفعلي والواقع العملي لهذه العلاقات تاريخيا في العهد الملكي، ثم في العهدين الجمهوري والجماهيري، حيث اتضحت هيمنة رأس السلطة على عملية صنع القرار في ليبيا تاريخيا.
استند التقرير في تقويم الاستجابات التشريعية إلى مدى تحقيقها لمعيارين: الأول هو مدى ضمان وجود سلطة تنفيذية قوية ومستقلة ذات صلاحيات محددة ومسؤوليات واضحة تمكنها من بسط سلطتها على مختلف أرجاء البلاد، والسيطرة على مقدراتها وتسيير أمورها، وهو ما لم تضمنه الوثائق الدستورية الصادرة بعد فبراير 2011، فلم ينص الإعلان الدستوري المؤقت على وجود رئيس تنفيذي بصلاحيات متوازنة مع صلاحيات المجلس الوطني الانتقالي أو المؤتمر الوطني العام. وفي حين اقترحت لجنة فبراير إيجاد سلطة تنفيذية قوية عبر انتخاب رئيس الدولة انتخاباً مباشراً، لم يعتمد المؤتمر الوطني العام هذا المقترح، وأحال الأمر إلى مجلس النواب فأصدر القرار 5 لسنة 2014 الذي اعتمد مقترح الانتخاب المباشر للرئيس، وإن لم يفعله. أما الاتفاق السياسي فلم ينص على وجود رئيس دولة منتخب، ولم يمنح مجلس النواب أي دور في اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورهن قرارات المجلس الرئاسي لضرورة إجماع الرئيس ونوابه وموافقة المجلس الأعلى للدولة. أما من حيث الواقع العملي، فقد رصد التقرير إصدار رئيس المجلس الرئاسي للقرارات بصورة فردية دون الرجوع إلى نوابه، أو المجلس الأعلى للدولة، أو مجلس النواب في حالات يقضي فيها الاتفاق السياسي بالرجوع إليهم.
وأظهر التقرير تباين تناول الوثائق الصادرة عن الهيئة التأسيسية لهذه القضية، حيث اقترحت مخرجات اللجنة النوعية الخاصة بشكل الحكم ونظامه نظاماً برلمانياً تختار فيه السلطة التشريعية الرئيس، الذي يختار بدوره رئيس وزرائه من الحزب أو التحالف المسيطر على هذه السلطة. بينما اتفقت مشروع لجنة العمل مع مشروع الدستور الصادر في يوليو 2017 في اقتراح أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا شعبيا مباشرا وأن يمنح اختصاصات واسعة ومتنوعة تعزز وجود سلطة تنفيذية قوية ومستقلة.
وتعلق المعيار الثاني في تقويم الاستجابات التشريعية بمدى معالجة التشريعات للعلاقة بين السلطات على نحو تكون فيه صلاحيات ومسؤوليات السلطتين التشريعية والتنفيذية واضحة ومحددة بما يضمن عدم افتئات إحداهما على الأخرى. وبين التقرير محاولة لجنة فبراير معالجة اختلالات العلاقة بين السلطتين كما نظمها الإعلان الدستوري، باقتراح انتخاب مجلس للنواب، وانتخاب رئيس للدولة انتخابا مباشرا، إلى جانب وضع مجموعة من التوازنات والضوابط المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. إلا أن التجاذبات السياسية حالت دون تطبيق مقترحات لجنة فبراير كاملة. في حين كان لغموض العلاقة وخللها بين المجلس الرئاسي باعتباره سلطة تنفيذية ومجلس النواب ومجلس الدولة بوصفهما سلطات تشريعية كما نص عليها الاتفاق السياسي في 2015، أثر على عدم تمكن هذا الاتفاق من إزالة الانقسام والصراع وإنهاء الاختلافات. وتتبع التقرير أثر أوضاع الانقسام السياسي والإيديولوجي والجهوي على مشروع الدستور 2017، التي انعكست انعكاسا واضحا في مقترحات المشروع التي حاولت المواءمة بين المواقف المختلفة بطريقة تخلق تنازعا حول الصلاحيات بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتعرقل عملها وتؤثر سلبا على أدائها.
أما في ما يخص استقلالية السلطة القضائية فقد عرض التقرير لتاريخ هذه القضية منذ استقلال ليبيا عام 1951 حتى فبراير 2011. ثم تناول التقرير الاستجابات التشريعية الخاصة بعلاقة القضاء بالسلطة التنفيذية بعد فبراير 2011 في النصوص الخاصة بتكوين المجلس الأعلى للقضاء، وأثر استبعاد وزير العدل من المجلس الأعلى للقضاء في الحفاظ على وحدة المجلس والقضاء، في ظل انقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية. أما موقف التشريعات من إدارات القضايا، والقانون، والمحاماة العامة، فقد أُسس التقويم على الموازنة بين إيجابيات وسلبيات شمول هذه الإدارات، مع القضاء والنيابة العامة، في مفهوم الهيئات القضائية. فعلى الرغم من فتحه المجال أمام التأثير على استقلالية القضاء فإنه أتاح الفرصة للتنقل بين مكونات الهيئات القضائية، وبالتالي تعيين قضاة من ضمن منتسبي الإدارات الثلاث، ولهذا أثره الإيجابي لما فيه من إثراءٍ للقضاء من ناحية، وتمكين لمنتسبات المحاماة العامة وإدارة القضايا من النساء، وتوسيع لفرصهن في شغل منصب القضاء من ناحية أخرى. كما أن اقتصار مفهوم السلطة القضائية على القضاء والنيابة العامة في مشروع الدستور لعام 2017، وتكريس مبدأ تنظيم الإدارات الثلاث بوصفها هيئات قضائية، وسكوت المشروع عن تحديد تشكيلة المجلس، قد يتيح فرصة تعيين قضاة من منتسبي الإدارات بضوابط محددة. فيما تناول التقرير علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية، من خلال النصوص التشريعية الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين. حيث حرصت كل الوثائق الدستورية بعد 2011 على توكيد استقلالية السلطة القضائية ووضعت الضمانات التي تكفل هذه الاستقلالية. على ذلك، تأثرت استقلالية القضاء والمحكمة العليا تأثرا كبير ا بالأوضاع والخلافات والانقسامات السياسية والعسكرية التي تفاقمت منذ 2014، واُستخدم حكم المحكمة العليا بشأن التعديل السابع ذريعة لعدم الاعتراف بمجلس النواب. ويعكس كل ذلك تأثيرات غياب الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها وأهمها فرض سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء.
أما في ما يتعلق ببعد العملية السياسية فقد رصد التقرير عدة تحديات تمثلت في العزوف عن المشاركة السياسية والتشكك في ملاءمة العملية الديمقراطية، والتشكيك في الأحزاب السياسية، وضعف المجتمع المدني، وتعاظم تأثير الولاءات الإثنية والقبلية والجهوية، والتطرف الديني. كما تقصى التقرير تأثير سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما ارتبط بها من خلافات أيديولوجية، وانقسامات سياسية، وصراعات عسكرية، ونزاعات قبلية وجهوية، على احتمالات التحول الديمقراطي وعلى مواقف الأفراد والجماعات تجاه قضايا الديمقراطية وآلياتها. وتمحورت هذه القضايا حول مدى ملاءمة النظام الديمقراطي، ودور الأحزاب السياسية، ومشاركة التيارات والأحزاب الإسلامية، وسياسات التمكين.
بالنسبة للقضية الأولى، أي مدى ملاءمة النظام الديمقراطي، استنتج التقرير أن سوء أداء المجالس المنتخبة على معظم المستويات وعجزها عن حل جُل المشاكل الاقتصادية والأمنية، فضلا عن تدني قدرات سلطات الدولة في الاستخراج والتنظيم والتغلغل والتوزيع، إلى جانب صراعات النخب السياسية الحاكمة وانقسامها، انعكس انعكاسا سلبيا على فكرة الانتخابات ذاتها، وأدى إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، والدعوة لوجود قيادة قوية تقود البلاد. وكل هذه مؤشرات سلبية حول احتمالات التحول الديمقراطي. وفي صدد الاستجابات التشريعية اتجهت للحفاظ على النمط الديمقراطي للدولة ولم تتأثر بتوجهات الرأي العام، سواء في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ومخرجات هيئة صياغة الدستور التي أكدت جميعها على المسار الديمقراطي، كما تعددت القوانين المنظمة للانتخابات على المستوى الوطني والمحلي. في المقابل، رصد التقرير استجابات سلبية تعد مثلا على تقليص العملية الديمقراطية، كقرار رئيس مجلس النواب بتعيين حاكم عسكري للمنطقة الممتدة من درنة إلى بن جواد، ومنحه سلطات واسعة قادته إلى اتخاذ إجراءات مقيدة للحريات العامة، وتعيينه عمداء للبلديات بدلا عن المجالس المنتخبة، وقيام الحكومة المؤقتة بعد إلغاء منصب الحاكم العسكري بتعيين مجالس تسيييرية للبلديات، دون الإعلان عن أي خطط لإجراء انتخابات بلدية.
وتمثلت القضية الثانية في دور الأحزاب السياسية، حيث ظهرت دعاوى مناوئة لمبدأ التعددية السياسية والحزبية نجمت عن سوء أداء الأحزاب وعقود من التنشئة السياسية التي كرست لثقافة سياسية معادية للنظام الحزبي. وكانت الاستجابات التشريعية في الغالب ايجابية حيث نص الإعلان الدستوري على واجب الدولة في إقامة نظام سياسي مدني ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وإلغاء قانون تجريم الحزبية، وصدور قانون الأحزاب السياسية وقانون الكيانات السياسية، وإنشاء لجنة لشؤون الأحزاب تتبع إدارة القانون. في المقابل، كان للأوضاع السائدة والثقافة المعادية للنظام الحزبي أثر على المنظومة التشريعية، حيث تضمن قانون انتخابات المؤتمر الوطني قيوداً على التمثيل الحزبي، وحظر قانون انتخابات الهيئة التأسيسية وقانون انتخابات مجلس النواب الترشح على أساس حزبي، كما نصت مسودة لجنة العمل للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على منع الأحزاب السياسية لمدة أربع سنوات من بدء العمل بالدستور الليبي الجديد، وهو ما عدلت عنه الهيئة في مشروعها الأخير، وإن كان يمكن تفسير تبنيها لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق الانتخاب الفردي على أنه تقييد للعمل الحزبي.
وتعلقت القضية الثالثة بمشاركة التيارات والأحزاب الإسلامية، حيث رصد التقرير تنامي التوجهات والمواقف الإقصائية تجاه كل الأحزاب الإسلامية، ويرجع هذا لبروز تحدي الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تتوسل العنف في فرض رؤاها، والتشكك في مدى التزام الأحزاب والتيارات الإسلامية بالعملية الديمقراطية ومخرجاتها بعد رفضها لنتائج انتخابات مجلس النواب، ومساهمة المجموعات الإسلامية المسلحة في عملية فجر ليبيا للاستيلاء على العاصمة ومنع مجلس النواب من مباشرة سلطاته، وما نتج عن ذلك من انقسام مؤسسات الدولة وتشظي العملية السياسية واندلاع الصراعات المسلحة. أما الاستجابات التشريعية فقد كرست حق المشاركة السياسية للجميع في الإعلان الدستوري. ولم يحظر قانون الأحزاب السياسية تأسيس أحزاب على أساس ديني، كما لم يمنع قانون الكيانات السياسية تشكيل كيانات سياسية على أساس ديني على الرغم من إشارته إلى حظر تشكيلها على أساس قبلي أو جهوي أو عرقي أو لغوي. كما خلت مخرجات الهيئة التأسيسية من أي نص يحظر تكوين الأحزاب على أساس ديني، وإن اتفقت على اشتراط أن تكون الأحزاب مؤسسة على الوحدة الوطنية، وشفافية التمويل، ونبذ العنف وخطاب الكراهية.
سياسات التمكين كانت هي القضية الرابعة، حيث استعرض التقرير الاستجابات التشريعية ووجد أن الاتجاه العام لدى المُشرع هو تخفيض الحصص المخصصة للنساء. فلم يكرس الإعلان الدستوري حصة معينة للمرأة. كما لم يقر الاتفاق السياسي حصة معينة لها رغم تأكيده على أهمية التمثيل العادل للمرأة ونصه على تشكيل وحدة لتمكين المرأة. أما مشروع الدستور 2017 فقد نص على حصة للمرأة لا تقل عن خمس وعشرين بالمائة من مجموع مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية وليس في كل المجالس المنتخبة، وذلك لدورتين انتخابيتين فقط. وفي حين اشترط قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012 نظام التناوب في القوائم الحزبية بين الرجال والنساء، خصص قانون انتخاب مجلس النواب نسبة 10% فقط من المقاعد للنساء. ويذهب التقرير إلى أن المكاسب التي حصلت عليها النساء إلى الآن مازالت هشّة وتحتاج لتدعيمها وتعزيزها على وجه السرعة بضمانات دستورية وتشريعية على أساس المساواة في المواطنة.
أما فيما يتعلق ببعد السياسة العامة فقد رصد التقرير أثر انقسام المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات المالية والنقدية في الدولة الليبية كمصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي في مفاقمة التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي كالسياسات الريعية، والفساد السياسي والإداري والمالي، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية. كما حدد التقرير أهم القضايا الخلافية المتعلقة ببعد السياسات العامة في الفساد المالي والإداري والسياسي، وكيفية توزيع إيرادات الموارد. وتوصل إلى أن الطبيعة الريعية التي تسم الاقتصاد الليبي وسيطرة الدولة على الأسعار والأسواق وجميع أشكال النشاط الاقتصادي، جعلت الدولة محور صراع عوضاً عن كونها مجرد مجال لتنظيم التنافس بين الفئات والجماعات المجتمعية المختلفة، كما أدت إلى تعزيز قدرة النخب الحاكمة على تكوين الثروات. فبرز اقتصاد مسيس يرتهن فيه الكسب الاقتصادي للقرب من السلطة عوضاً عن ارتهانه لزيادة الإنتاجية والكفاية الاقتصادية، في الوقت الذي لم تستثمر الدولة استقلاليتها المالية في تشييد قاعدة اقتصادية مكينة وطويلة الأمد.
ورصد التقرير هيمنة ثقافة الغنيمة في ظل ضعف المؤسسات الحكومية وغياب المساءلة، فنشأت بيئة خصبة للفساد والنهب، وتفاقم النمط التوزيعي الريعي والارتهان شبه الكامل للدولة ومؤسساتها بعد 2011. حيث عملت سلطات الدولة على شراء ولاء الأفراد والجماعات عبر مجموعة من القرارات والسياسات المتعلقة بتوزيع منح مالية على المواطنين وقيام المؤتمر الوطني العام بسن قانون بتعويض السجناء السياسيين السابقين عن فترة سجنهم. كما حدد قضيتين خلافيتين هي الفساد المالي والإداري والسياسي، وكيفية توزيع إيرادات الموارد.
بالنسبة لقضية الفساد الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وظهور فئات كثيرة من العاملين في القطاع الحكومي والمصرفي والتجار التي كوّنت ثروات طائلة في ظل هشاشة المؤسسات وعدم فاعلية الجهات الرقابية، ما زاد من تعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع. ورصد التقرير عديد الاستجابات التشريعية التي تستهدف مكافحة الفساد، ولكنها، على الرغم من تعددها هذا، لم تكن فعالة. فعلى المستوى الدستوري لم يشر الإعلان الدستوري 2011 للفساد أو مكافحته، غير أنه نص على آليات النزاهة وضوابطها. أما مشروع الدستور2017 فقد ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وكشف حالاته ومعالجة آثاره، كما دستر هيئة مستقلة للشفافية ومكافحة الفساد. أما القوانين العادية فقد تأثرت فعاليتها بوجود مثالب في القوانين ذاتها، وكذلك الحال بالنسبة لهيئات مكافحة الفساد المتعددة.
وتناول التقرير القضية الثانية في بعد السياسة العامة، وهي كيفية توزيع إيرادات الموارد وما تثيره من نزاع اقتصادي وصراع سياسي، حيث تعلق الأمر بالخلاف حول توزيع إيرادات الموارد التي يجري التحكم فيها مركزيا. وفي رصد الاستجابات التشريعية تبين أن الإعلان الدستوري2011 لم يتطرق لقضايا الحكم المحلي وطبيعة العلاقة بين السلطة المركزية والوحدات المحلية، لكنه نص على ضمان الدولة لعدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن الدولة ومناطقها. في حين نص الاتفاق السياسي في المبادئ الحاكمة على تفعيل النظام اللامركزي أساسا للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة، وعدم جواز التحكم في الثروات الطبيعية أو التصرف فيها إلا من قبل السلطات الرسمية للدولة، ووفق التشريعات النافذة، وعدم إقحامها في أي نزاع سياسي. وعلى الرغم من محاولة الهيئة التأسيسية التوفيق في مشروع الدستور بين مطالب أنصار النظام الموحد وأنصار النظام الفيدرالي داخل الهيئة وخارجها، لم ينجح المشروع في تبديد مخاوف المطالبين بالقضاء على التهميش السياسي والإجحاف الاقتصادي، فلم يشمل، في نظرهم، ما يكفي من الضمانات التي تكفل التوزيع العادل لعوائد الموارد والخدمات، كما لم يدستر صلاحيات وحدات الحكم المحلي التشريعية والتنظيمية والتنفيذية، بل أحال معظمها لقوانين تصدرها السلطة التشريعية المركزية.
ويذهب التقرير في تقويمه للاستجابات التشريعية إلى الحاجة لتشريعات تعالج هذا التحدي بما يؤسس لبناء توافق وطني يعزز آفاق نجاح بناء الدولة والأمة أيضاً، وخاصة في ما يتعلق باللامركزية المالية وتعزيز التنمية ودور القطاع الخاص، بحيث يُنظر إلى الجدل حول الفيدرالية والحكم المحلي كأولوية تنموية للتوصل إلى إستراتيجية أو رؤية وطنية للنظام اللامركزي والحكم المحلي. فهناك حاجة ماسة إلى نقاش وحوار وطني واع حول العلاقة بين السلطة المركزية والمحليات في مستوياتها المختلفة عبر نموذج أو مقاربة من أسفل إلى أعلى ونموذج تنموي تشاركي للتخطيط وإدارة الاقتصاد إدارة ديمقراطية. وهذا سيكون حاسما في إنشاء نظام حوكمة متمركز على المحليات وبشكل يخدم هدف التنمية.
وأخيرا تناول التقرير البعد الدولي الذي تمحور حول تقصي دور العامل الخارجي في الأزمة الليبية وتأثيراته على بناء الدولة، وبالتالي مسار المصالحة الوطنية. فعرض وقوّم دور الأطراف الدولية المختلفة كالمنظمات الدولية، والقوى الغربية، والقوى الإقليمية. ورصد التقرير تأثر الأوضاع الداخلية في ليبيا تأثرا سلبيا بتضارب مصالح القوى الدولية والإقليمية، واختلاف أولوياتها المتمثلة في محاربة تنظيم الدولة وغيره من الجماعات الإرهابية، والسيطرة على الهجرة غير القانونية إلى أوربا، وضمان استمرار تدفق صادرات النفط والغاز، عن أولويات الليبيين، والأثر السلبي لتحول ليبيا إلى ساحة لصراعات الأطراف الأجنبية على عملية بناء الدولة. من ناحية أخرى وضح التقرير أثر فشل التسويات السياسية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث كان الليبيون يأملون في أن تساعدهم على مواجهة تحديات هذه العملية ومعالجة المختنقات الاقتصادية. فرصد تدني مصداقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدى كثير من الليبيين بوصفها وسيطا نزيها، والاتهامات المتزايدة لها بإقصاء بعض الأطراف ومحاباة أخرى، وعدم تعبير مفاوضات الصخيرات عن تمثيل سياسي واجتماعي ومناطقي منصف، وعدم إشراك كل الأطراف المحلية الفاعلة في هذه العملية. كما فقد كثير من الليبيين الثقة في بعض الأطراف الخارجية بسبب اعتقادهم في انحيازها لتيار بعينه على حساب تيارات سياسية أخرى.
وقد خلص التقرير إلى اقتراح رؤية للحكم الوطني تحدد الغايات وتقترح السياسات والتشريعات لإحداث تحول كيفي في منظومة المجتمع لتطوير مؤسساته وتعزيز هيبة الدولة وسلطتها وضمان أمن الوطن واستقراره، وتفعيل دور الدولة الإقليمي والعالمي، وإصلاح الاقتصاد وتنويعه، وإعداد دراسات تشخص الخطاب السياسي والأمني وتقومه، وتحدد سبل تحديثه.