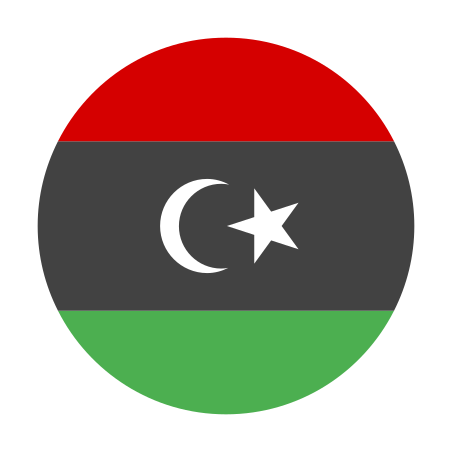المرحلة البحثية الرابعة: العدالة الانتقالية
استغرقت مرحلة بحث شاغل العدالة الانتقالية من 16 أكتوبر 2019 إلى 15 أبريل 2020، وتناولت عددًا من قضايا العدالة الانتقالية الخلافية المفصلية، ابتداء من مدى شرعية مفهومها، وانتهاء بمدى ملاءمة تفعيل قانونها الرئيس: القانون رقم 29/2013، ومرورًا بمدى إمكانية تطبيقها، وإطارها الزمني والموضوعي، ومدى مناسبة كشف الحقيقة، والتخيّر بين العفو والعدالة، وتحديد أوجه جبر الضرر ومداه ومدى مسؤولية الدولة عنه، والموقف من إصلاح المؤسسات وما إذا كان يستلزم عزلًا للعاملين فيها ومعيار هذا العزل: الوظيفة أم السلوك، ومدى تميز ليبيا بخصوصية ثقافية في شأن العدالة الانتقالية ومدى وجوب استلهامها قضاء دوليًّا، فضلًا عن مدى مناسبة الرجوع إلى قضاء دولي، خالص أو مختلط، مكملًا للقضاء الوطني أو بديلًا عنه، في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان.
| Project Manager | سليمان إبراهيم |
| Main project | دور القانون في المصالحة الوطنية في ليبيا |
ملخص تقرير شاغل العدالة الانتقالية
يقارب هذا التقرير دور القانون في معالجة قضايا رئيسة متعلقة بالعدالة الانتقالية بوصفها مقدمة لازمة لتحقيق المصالحة الوطنية. ويفترض إنه لفهم العدالة الانتقالية: المواقف المختلفة من قضاياها، وما صدر بشأنها من استجابات، وتقويم هذه الاستجابات؛ يلزم استحضار سياقاتها القيمية، والتاريخية، والسياسية-التشريعية.
أولًا: السياق القيمي
أكد التقريرُ البعدَ القيمي للعدالة الانتقالية، فهي تقوم على مبدأ إعلاء المصلحة العامة على الخاصة، بكل ما يتضمنه هذا الإعلاء من إيثار وتضحية وفداء. لا تستهدف آليات العدالة الانتقالية فحسب إشباع روح العدالة، بل تستهدف أيضا، وأساسًا، تعظيمَ حظوظ المصالحة الوطنية، وترسيخ السلم الاجتماعي، وتأسيس دولة القانون، وتسريع الانتقال إلى الديمقراطية على أسس سليمة؛ وكل هذا إنما يجعل من العدالة الانتقالية مشروعًا وطنيًّا، فضلًا عن كونها مشروعًا عدليًّا وحقوقيًّا.
كما فرق التقرير بين المشاعر الإنسانية والسلوكات البشرية في سياق العدالة الانتقالية، وأوضح صعوبة تطويع الأولى كصفح الضحية وشعور الجلاد بالأسف، ومِنْ ثَمَّ استحالة تطلبها. بعكس الثانية التي يمكن تطويعها والمطالبة بها مثل: عفو الضحية وإبداء أسف الجاني، ويدرك التقرير أن العدالة الانتقالية ليست بأي حال وصفة لإصلاح كل ما يعاني منه المجتمع من اختلالات وانتهاكات. ففي حين أنها قد تعين النضالات الاجتماعية والمساعي السياسية طويلة الأمد والرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإنها لا تحل محلّها، ولا تكفي بديلًا عنها.
كما يدرك التقرير أن البحث في الأسباب التي جعلت أبناء شعب ما يدأبون على الشعور والانفعال وفق أساليب سلبية بعينها قد يكشف عن طبيعة التنشئة الاجتماعية التي تربّوا في كنفها، وقد يوجّه هذا الكشف إلى أساليب تنشئة بديلة تسهم في جعلهم أقلّ عرضة للأحوال النفسية التي ترجَّح ترجمتها إلى سلوكات عنيفة. ولزام على أساليب التنشئة الاجتماعية أن تسهم في غرس قيم محابية للمشاعر الإيجابية التي قد تكون سببًا في التراحم والتكاتف، وأن تسعى إلى مناوأة المشاعر السلبية التي قد تكون سببًا في البغي والعدوان.
ثانيًا: السياق التاريخي
للعدالة الانتقالية في ليبيا سوابق تاريخية بعيدة المدى وقريبته، وإن لم تُسمَ بها حين تطبيقها؛ "حتحات على ما فات" وما سبقها وصاحبها وتلاها من مواثيق قبلية تعد نوعًا من العدالة الانتقالية المبنية على فكرة السلام في مقابل العدالة لأجل المصالحة وبناء الدولة.
ولعل من أبرز محاولات نظام القذافي خلال عقده الأخير المبادرات التي كانت جزءًا من مشروع إصلاحي رعاه سيف الإسلام القذافي وارتأى البعض أنها تندرج في سياق العدالة الانتقالية، وقد أثارت في حينها، وما زالت تثير، نقاشًا حول مدى جديتها ونجاعتها.
وقد شملت حينها: علاج آثار مذبحة "أبو سليم" بتعويض أسر الضحايا، ولم يشمل العلاج كشف حقيقة ما جرى؛ السماح بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأقليات الأثنية بقيد أسمائهم، إذا كانت أسماءً لأصول معبرة عن معاني الأصالة الليبية أو توارث نقلها وفقًا للتقاليد والعادات، ولم يلغ القانون الذي يحظر استخدام غير العربية؛ تعويض المتضررين من القوانين المقيّدة للملكية العقارية الخاصة على ما شاب تطبيق هذه القوانين من "انحرافات" ولم تلغ تلك القوانين؛ إلغاء محكمة الشعب الاستثنائية وإن نقلت صلاحياتها الاستثنائية للمحاكم والنيابات التخصصية؛ وأخيرًا تكليف لجنة من خبراء ليبيين وأجانب بإعداد مشروع لدستور، أُخضع لاحقًا لمراجعات لجان أخرى جعلته في خاتمة المطاف متسقًا مع أيديولوجيا النظام، وعلى الرغم من ذلك، فإن المشروع لم يصدر.
وبالرغم من محدودية مبادرات الإصلاح التي قادها سيف الإسلام، فإنها قد أسهمت في خلق بيئة أتاحت لليبيين بشكل متزايد، وغير مسبوق، التعبير عن مظالمهم في الفضاء العام. فعلى سبيل المثال، دأبت أسر ضحايا مذبحة أبو سليم على الاعتصام أسبوعيًا أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية مطالبة بالكشف عن حقيقة ما جرى، وقد كان القبض على محامي هذه الأسر شرارة البدء في ثورة فبراير 2011 التي انتهت بإسقاط النظام.
ثالثًا: السياق السياسي - التشريعي
استحضار السياق السياسي منذ فبراير 2011 لازم لفهم، ومن ثم تقويم، ما صدر من تشريعات عدالة انتقالية. وفي هذا الصدد، يمكن رصد تصاعد تدريجي لروح ثورية تنادي بالقطع مع النظام السابق والإعلاء من شأن الثائرين عليه، أعقبه تراجع لهذه الروح مبعثه خيبة أمل في تحقيق الثورة أهدافها، ومراجعة للموقف من النظام السابق، وانتهاكاته، من ناحية، وللموقف من فئات ارتبطت بالثورة وخصوصًا الإسلامية منها، من ناحية أخرى. وقد عبَرت التشريعات التي وضعتها السلطات الانتقالية عن هذه التغيرات؛ سواء المجلس الوطني الانتقالي (2011- 2012) - حيث توجهت تشريعاته نحو التمييز بين انتهاكات النظام السابق ولاحقاته في سياق العدالة الانتقالية - أم المؤتمر الوطني عام (2012- 2014)، الذي جسدت تشريعاته بشكل أوضح نزعة تمييزية ضد النظام السابق بسبب الروح الثورية التي صبغت عمله. وأخيرًا مجلس النواب الذي سنّ تشريعات تكشف عن مراجعات للموقف من النظام السابق، من ناحية، وتلاحق بالمساءلة قوى إسلامية تنسب إلى الثورة من ناحية أخرى.
أما الاتفاق السياسي (2015) فقد كان تغييب أنصار النظام السابق عن الحوار الذي قاد إليه وعناية هذا الاتفاق ببناء توافق بين أطراف صراع لاحق على فبراير 2011، من ناحية أخرى، وهذا يفسر نصوص الاتفاق المتعلقة بالعدالة الانتقالية؛ فهو يتخذ من ثورة فبراير مرجعية له، ولكن في الآن ذاته يقر بالانتهاكات التي وقعت بعدها بما في ذلك تلك المنسوبة إلى قوى ثورية، كتلك المتعلقة بمعالجة أوضاع المفقودين والمحتجزين والنازحين. وفي حين يجعل الاتفاق تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبدأً من مبادئه، فإنه يربط هذه الآليات بما هو مقرر في القانون رقم 29/2013.
كما رصد التقرير تباين المواقف بشأن العدالة الانتقالية في عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كذلك، فقد رصد فروقات بين مخرجات مسودة 2016 وبين مشروع 2017، معللًا ذلك بتأثير السياق السياسي العام وأثر البيئة التي انتخبت وعملت فيها الهيئة.
وحيث تكشفت مجموعات التركيز عن مواقف متباينة من القضايا التي تثيرها العدالة الانتقالية، فقد رصد التقرير هذه المواقف، وتعرّف إلى الحقوق المطالب بصونها، والحجج الداعمة لهذه الحقوق، والمخاوف المضمرة في هذه الحجج، ليتمكن من اقتراح آليات مناسبة، تبدد المخاوف وتردّ المظالم، وتقوّم في ضوئها الاستجابات التشريعية القائمة والمقترحة.
القضية الأولى: شرعية المفهوم
ثمة من يتخذ موقفًا ينكر ابتداء مفهوم العدالة الانتقالية، بسبب ما يساوره من شكوك في شرعيته القانونية أو مناسبته الظرفية. وفي المقابل، ثمة من يدافع عن شرعية مفهوم العدالة الانتقالية أو مناسبته الظرفية. وعلى الرغم من أن خصوم مفهوم العدالة الانتقالية محقون في توكيد لزوم تأمين ضمانات للحقوق الطبيعية في الظروف الطبيعية، فإن الغايات السامية التي ترنو إليها العدالة الانتقالية إنما توجب في الفترات الاستثنائية التضحية ببعض منها، ولكن هذه التضحية ينبغي أن تتم عبر تأسيس دستوري للعدالة الانتقالية، فيُضمّن الدستور نصًا على غرار الدستور التونسي (الفصل 148/9)، مثلًا، يلزم "الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن".
وبرصد تشريعات ما بعد فبراير 2011، يتضح أن السلطات الانتقالية على اختلافها قد توافقت على أهمية العدالة الانتقالية، وإن اختلفت في مقاربتها لقضاياها؛ فهي على سبيل المثال، لم تؤسس للعدالة الانتقالية دستوريًا، إذا ما تجاوزنا ما ضمنته هيئة صياغة الدستور في مشاريعها مسوداتها وآخرها مشروع المعلن عنه في يوليو 2017. والاستثناء الوحيد هو العزل السياسي الذي كان موضوعًا لتعديل للإعلان الدستوري نفى عنه تعارضه مع مبدأ عدم التمييز، وذلك في محاولة واضحة للتصدي لطعن مرتقب في دستوريته.
القضية الثانية: مكنة التطبيق.
تثار في الأوساط المثقفة، حتى أوساط عموم الناس، قضية فحواها : أقيام دولة قادرة على فرض الأمن وتأمين الاستقرار شرط لازم، أم غير ضروري، للشروع في تطبيق آليات العدالة الانتقالية. فكما كشفت النتائج التي أسفرت عنها جماعات التركيز واللقاءات المعمقة، هناك من ينكر إمكان تطبيق آليات العدالة الانتقالية في بلادنا لأسباب ظرفية، على تسليمه بشرعية مفهومها، وبأن حينًا من الدهر سوف يأتي تستبين فيه ضرورتها. في المقابل، هناك من يذهب إلى وجوب الشروع فورًا في تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
ورأي التقرير أن الموقف المناسب من مسألة مكنة التطبيق هو موقف وسط. صحيح أن للدولة دورًا محوريًّا في هذا الشأن، ومن شأن تشظي مؤسساتها أن يضعف هذا الدور، وقد ينحرف بالعدالة الانتقالية عن أهدافها، كما تدل التشريعات التي سنتها السلطات الانتقالية المتوازية في إطار تحاربها؛ ولكن الاعتراف بمحورية هذا الدور وضعفه الراهن لا يصلحان حجة لتأجيل تفعيل العدالة الانتقالية، فإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإن كانا ضروريين، فإنهما غير كافيين لتحقيق المصالحة الوطنية، الضامن لديمومة الحل السياسي؛ إذ يستلزم هذا خلق توافق حول قضايا خلافية رئيسة تعد تلك المتعلقة بالعدالة الانتقالية في مقدمتها. وفي حين أن خلق توافق حول هذه القضايا ليس أمرًا هيّنًا، وقد يستغرق زمنًا طويلا، فإنه لازم لتحقيق مصالحة وطنية مستدامة، وبناء الأمة والدولة.
القضية الثالثة: الإطار الزمني والموضوعي
كشفت اللقاءات المعمقة وجماعات التركيز عن اختلافات شديدة بشأن تحديد الفترة الزمنية التي ينبغي أن تكون الانتهاكات الواقعة فيها موضع معالجة، ونوع هذه الانتهاكات، ولكل موقف حججه التي يستند إليها ومواقفه السياسية التي يعكسها.
ويميل التقرير إلى اتخاذ موقف مؤداه أن يرتهن الإطار الزمني للهدف الأساسي من مشروع العدالة الانتقالية، الذي يتمثل في المصالحة الوطنية، بحيث يُستبعد من هذا الإطار كل انتهاك لا يؤثر في نجاح مساعيها، كأحداث طلاب الثانوية في يناير1964 مثلا. فإذا استبان أن وقائع بعينها حدثت ذات أثر واضح على تحقيق المصالحة، لزم استهدافها من قبل آليات العدالة الانتقالية، حتى إذا مرت عقود طويلة على حدوثها.
القضية الرابعة: كشف الحقيقة
رصد التقرير بشأن هذه القضية موقفين رئيسين: أولهما يدعو إلى كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات؛ لأن في ذلك رادعًا لتكرار ارتكابها، وتهدئة لصدور الضحايا الموغَرة، ومنحها فرصة التفضل بالعفو عن جلاديها. أما الموقف الثاني، فيدعو إلى الإمساك عن كشفها؛ لأنه قد يثير المزيد من الخصومات والاحترابات؛ ولأن الحل لا يكمن في نبش الماضي ونكأ الجراح بالتفتيش في دفاتر قديمة، بل في طي صفحتها، وإشغال الناس بمشاريع اقتصادية تمكّنهم من عيش حياة كريمة.
وبالنسبة إلى الاستجابات التشريعية، سنّ المشرع، تشريعات للعدالة الانتقالية كرّس، في نطاقها، كشف الحقيقة، وكانت البداية بالقانون رقم 17/2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي أنشأ هيئةً لتقصي الحقائق والمصالحة، مارست عملها لفترة وجيزة قبل أن يصدر القانون رقم 29/2013 بشأن العدالة الانتقالية، الذي ألغى القانون رقم 17/2012 وقرر إعادة تشكيل الهيئة. ولأن إعادة التشكيل لم تتحقق بعد، تعد تجربة هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، على قصرها، مهمة لأنها الوحيدة.
وفي تقويم الاستجابات التشريعية، فإن نقطة الانطلاق هي أن معرفة الحقيقة حق أجدر أن يصان، في حين يُتصوَّر قيام العدالة الانتقالية دون مساءلة جنائية، فإنه يتعذر قيامها دون كشف للحقيقة، فمعرفة الحقيقة مقدمة لازمة لا يتصور أنه يمكن دونها جبر للضرر أو إصلاح مؤسسي. والعدالة الانتقالية في ليبيا تقوم على أربع حقائق. أول هذه حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وحرياته الأساسية، والشأن في كشفها تحرير الضحايا ومن اتهموا دون سند بهذه الانتهاكات، وعانوا لهذا من رفض اجتماعي. أما ثانيها، فيتعلق بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يكفل كشف حقيقة التهميش والإقصاء الذي تدعيه مناطق أو جماعات بعينها، ويكفل، في حال التحقق من صحته، تكريس تمييز إيجابي لمصلحتها؛ فضلًا عن الكشف عن حقيقة ما يرتبط بانتهاكات الحقوق الاقتصادية من فساد. وأما ثالثها، فيتصل بكشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة بحقوق المكونات الثقافية واللغوية. ويتعلق رابعها بكشف أسباب النزاع المسلح بين المدن الليبية بعد فبراير 2011، فجذور كثير من هذا النزاع تسبق هذا التاريخ بفترة طويلة، ويلزم لمعالجتها بشكل نهائي الكشف عن حقيقتها. على هذا، فإن أهمية كشف الحقيقة تتعدى أفراد الضحايا إلى بناء الدولة على أساس مستقر.
القضية الخامسة: مدى ملائمة العفو
يصاغ السؤال عن مدى ملاءمة العفو عن مرتكبي انتهاكات حقوق إنسان في صورة التخيّر بين السلام والعدالة، فيُحتج للعفو بأنه محقق للسلام، أو المصالحة، ويُحتج ضده بأن فيه إهدارًا للعدالة. وفي الحالة الليبية، سُنّت قوانين للعفو عكست تأثرًا واضحًا بالسياق السياسي السائد حين سنها، وقد احتج لها بأنها محققة للسلام، ورأى فيها البعض بأنها لم تكرس فقط حصانة من المساءلة الجنائية، بل حالت أيضًا دون إعمال آليات العدالة الانتقالية الأخرى من كشف للحقيقة، وجبر لضرر الضحايا، وإصلاح مؤسسي.
المثل الأبرز، والأقدم، هو القانون رقم 35/2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم. فقد استثنى هذا القانون من العفو الجرائم التي ارتكبها زوج القذافي، وأبناؤه وبناته، أصالة أو بالتبني، وأصهاره وأعوانه والقانون رقم 38/2012 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الذي صرّح بالعفو عن جرائم "الثوار".
المثل الآخر هو القانون رقم 6/2015 بشأن العفو العام الذي سنه مجلس النواب. الذي فُسّر بأنه يشمل جرائم منسوبة إلى أنصار النظام السابق، وقد يكون سند هذا التفسير نصّ المادة الأولى الذي صرح بشمول العفو لـ "جميع الليبيين"، في شأن جرائم ارتكبت "خلال الفترة من تاريخ 15 /2/ 2011"، وهذا تاريخ بدء ثورة فبراير وارتكاب أفعال هدفت إلى إخمادها. وقد احتج لسن القانون بأن فيه تحقيقًا للمصالحة الوطنية، وإن كان البعض قد اعترض على استغلاله في تأمين حصانة من المساءلة الجنائية، وإهدار حقوق بعض الضحايا؛ على الرغم من أنه، في حد ذاته، لا يؤمّن تلك الحصانة ولا يهدر هذه الحقوق؛ ذلك أنه قد أخرج جرائم خطيرة من نطاق العفو وعلق العفو على شروط تتعلق بالتوبة عن الفعل، وعلى قرار كاشف عن استيفاء الشخص المعني لهذه الشروط.
وفي تقويم مدى ملاءمة قوانين العفو سالفة الذكر، فإن نقطة الانطلاق هي تحديد أثرها في العدالة الانتقالية بآلياتها المختلفة. فالعفو، كما يقرر قانون العدالة الانتقالية رقم 29/2013، هو إحدى آليات هذه العدالة (المادة 5 فقرة 6)، ولكن هذا مشروط بأن لا يفرغها من محتواها.
القضية السادسة: جبر الضرر
تعددت المواقف في شأن قضية جبر الضرر. فالبعض يرى أنه لا مدعاة للجبر أصلا؛ لأن الانتهاكات طالت الجميع، فلم تبق ولم تذر؛ أو لأن فيه، أي الجبر، استنزافًا لموارد الدولة. وفي مقابل هذا، هناك آراء تتفق على وجوب جبر الضرر، ولكنها تختلف في تفاصيله.
ويلاحظ في شأن الاستجابات التشريعية تعددها، وأنها، وإن اشتركت في التركيز على التعويضات النقدية، اختلفت في نطاق جبر الضرر على نحو استتبع تمييزًا بين الضحايا. وقد تجلى هذا الاختلاف أيضًا في تنفيذ الجبر المقرر. وقد يجد عدم تنفيذ بعض هذه التشريعات مبرره في أنها أرهقت الدولة بالتزامات لا طاقة لها بها، وقد يفسر هذا التصور حكمًا حديثًا للمحكمة العليا نفت فيه مسؤولية الدولة عن جبر الضرر الناشئ عن ثورات.
والراهن أن تعدد الاستجابات التشريعية لا يقتصر على جبر الضرر، بل يتعداه إلى مسائل العدالة الانتقالية المختلفة، وإن كان في شأن جبر الضرر أجلى. فبالإضافة إلى القانون العام في شأن العدالة الانتقالية، أي القانون رقم 29/2013، تعددت التشريعات المعالجة لانتهاكات خاضعة للعدالة الانتقالية، ومثلها تلك المتعلقة بمذبحة أبو سليم، والسجناء السياسيين، والملكية العقارية، وضحايا العنف الجنسي.
وبتعدد هذه التشريعات، تعددت أوجه جبر الضرر ومداه وآلياته على نحو ميّز بين الضحايا. ولهذا، فإن المهم - بعد مراجعة نصوص القانون رقم 29/2013 المعيبة على النحو المفصل في ثنايا هذا التقرير، وتعديل هذا القانون أو إبدال آخر جديد مكانه - توحيد إطار جبر الضرر، وقد يقتضي هذا إلغاء التشريعات المتعددة والاكتفاء بالقانون رقم 29 أو بديله.
القضية السابعة: الإصلاح المؤسسي
كشفت جماعات التركيز واللقاءات المعمقة عن موقفين رئيسين متضادين في هذا الشأن. بالنسبة إلى أولهما، فإن إصلاح مؤسسات النظام السابق الأمنية أمر غاية في الأهمية، وكذا شأن إصلاح مؤسسة القضاء، التي شابها الفساد، ومؤسسة الإعلام، التي أسهمت في تعميق الشرخ الاجتماعي، خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة. أما بالنسبة إلى الموقف الثاني، فإن كل مؤسسات الدولة في حاجة إلى إصلاح، فالعطب استشرى فيها جميعها، ولا معنى للحديث عن إصلاح مؤسسات دون غيرها.
ويلاحظ أن مفهوم الإصلاح المؤسسي قد اختزل إلى حد كبير في العزل السياسي والإداري، ويلاحظ كذلك أن الآراء التي كشف عنها البحث قد تأثرت إلى حد بعيد بما سُنّ من تشريعات، وهي تتمحور أساسًا حول ثنائية العزل والتمكين، حيث تبنى قانون العزل السياسي والإداري رقم 13/2013 مقاربة مبنية على استبعاد شاغلي وظائف بعينها دون نظر إلى سلوكهم حين شغلها. ووفقًا له، فإنه يمنع من شغل وظائف قيادية، أو الاستمرار في شغلها، مَنْ تولى وظائف محددة في عهد القذافي، منذ بدء حكمه في 1/9/1969، دون مراعاة لسلوكهم خلال توليهم تلك الوظائف، وقد وُوجه القانون بانتقادات كثيرة، وطُعن فيه بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا، وهو طعن فضلتْ السكوتَ عن الحكم فيه رغم مرور سنين على تقديمه، وانتهى الأمر بإلغاء هذا القانون على نحو رسمي أو فعلي.
وفي تقويم الاستجابات التشريعية سالفة الذكر، فإن المأخذ الأول يتعلق باختزالها الإصلاح المؤسسي في العزل السياسي والإداري. نعم، يعد العزل بالفعل آلية من آليات الإصلاح المؤسسي، ولكنه ليس الآلية الوحيدة. ينبغي أن يشمل الإصلاح المؤسسي برامج تدريبية شاملة لفائدة المسؤولين والموظفين العامين في مجال حقوق الإنسان. كذلك، فإن الإصلاح ينبغي أن يتطرق إلى تحديث الهيكلية الإدارية والحوكمة الرشيدة وسائر سبل التطوير المؤسسي. والأهم من هذا كله، أن يشمل الإصلاح التشريع، سواء ما تعلق منه بالعدالة الانتقالية، أو بغيرها من الجوانب.
كذلك، فإنه فيما يتعلق بالعزل السياسي والإداري، يؤخذ على ما سنّ من تشريعات تأسسها على شغل الشخص المعني لمنصب بعينه دون نظر إلى مسلكه حين شغل ذاك المنصب. وقد سبق لفريق البحث أن خلص إلى أن هذا النوع من العزل يعد إقصائيًّا، ومن شأنه خلق انقسام سياسي واستقطاب مجتمعي حاد، ودليل فشل في كفالة حق المشاركة السياسية للجميع. ولهذا، فإنه ينبغي أن يقتصر الاستبعاد على من تلوثت أيديهم بدماء الليبيين أو أموالهم.
القضية الثامنة: الخصوصية الثقافية
السؤال في هذه القضية أهناك بيئة محابية لقيم العدالة الانتقالية في بلادنا؟ وهل التجربة الليبية متفردة إلى حد يوجب استحداث آليات خاصة؟ وقد تباينت المواقف المتخذة من هذه المسألة، فهناك من يرى في القيم السائدة فرصة لتحقيق العدالة الانتقالية، ويميز البعض في إطار هذا الرأي الأخير بين القيم السائدة مناطقيًا، وينفي البعض الآخر هذا التمييز. وخلافًا لهذا، يذهب فريق آخر إلى أن القيم السائدة تعد في الحقيقة عائقًا أمام تحقيق العدالة الانتقالية.
وقد لاحظ قانون العدالة الانتقالية رقم 29/2013 أهمية دور القيادات التقليدية في تحقيق المصالحة، ولكنه جعل منه دورًا مساندًا لا رئيسًا. فالقانون قد أوجب على إدارة التحكيم والمصالحة، إحدى إدارات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، أن تتواصل بشكل دائم مع لجان المصالحة وحكماء المناطق لإعادة اللحمة الوطنية وتحقيق شروط المصالحة بين المناطق (المادة 8/6)، وهو كذلك يجيز للهيئة أن تستعين "بالشيوخ والحكماء ممن عرفوا بدور فعال في حل النزاعات الأهلية بالطرق العرفية".
القضية التاسعة: مدى حصرية اختصاص القضاء الوطني
يدور السؤال هنا حول حدود دور القضاء الوطني في معالجة انتهاكات عدالة انتقالية؛ هل يقتصر عليه، أم تشاركه فيه، بل قد تحظى بالأولوية عليه، هيئةُ تقصي الحقائق، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل يتصور أن يشاركه فيه، أو يحل بديلًا عنه، قضاء دولي، أو هل يُفضَّل هذا؟
بالنسبة إلى المسألة الأولى، فإن الأمر معقد تشريعًا، وبعد تقويم لتلك المسألة يصل التقرير إلى أن الحل المتوازن يتمثل في أن يأخذ القضاء ما خلصت إليه الهيئة بعين الاعتبار، ولكن من غير التزام به، إذ ينبغي للقضاء أن يتمتع بحق إجراء تقاضٍ مستقل، وينبغي أن يكون متاحًا للضحايا بشكل عام الالتجاء إلى القضاء، إن لم تنصفهم الهيئة.
بالنسبة إلى المسألة الثانية، فهي تتعلق بمدى ملاءمة إسناد الاختصاص بانتهاكات عدالة انتقالية إلى قضاء دولي، في صورة محكمة مختلطة أو خاصة بالحالة الليبية، أو إلى المحكمة الجنائية الدولية المخولة بموجب قرارات مجلس الأمن بالنظر فيما وقع ويقع في ليبيا من جرائم داخلة ضمن اختصاصها؛ هل من الملائم التمسك بأولوية اختصاص القضاء الوطني بهذه الجرائم، ومن ثم دفع اختصاص المحكمة، بوصفه اختصاصًا تكميليًا، المتوقف على عجز أو عزوف القضاء الليبي عن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ أم أن الأولى التسليم بعجز هذا القضاء عن محاكمة هؤلاء في الوضع الراهن، والإقرار باختصاص المحكمة الجنائية الدولية منعًا لإفلاتهم من العقاب؟
وقد كشفت المقابلات ومجموعات التركيز عن اختلاف الآراء بشأن مدى ملاءمة حصرية اختصاص القضاء الوطني. فالبعض، من ناحية أولى، تمسكوا باختصاص القضاء الوطني، وفي مقابل هذه الآراء، هناك أخرى لا تمانع، بل تفضِّل، اللجوء إلى قضاء دولي.
القضية العاشرة: مدى ملاءمة تفعيل القانون رقم 29/2013 بشأن العدالة الانتقالية
في إجابة عن التساؤل حول مدى ملاءمة إصدار المشروع من ناحية إجرائية، وسياسية، وموضوعية؛ يكشف التقرير عن صعوبة القطع برأي حول مدى ملاءمة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية الآن، وحسب المسار المتبع حاليًا، وإمكان أن يؤدي هذا الإصدار بالفعل إلى تفعيل هذا القانون. ولكن إذا ما تم تقويم هذه الخطوة في ضوء البدائل الأخرى، مثل الاستمرار في عدم تفعيل القانون، كما هو حاصل الآن، والانتظار إلى أجل غير مسمى لوضع بديل يتجاوز عيوبه، فإنه يبدو أن محاسن إصدار اللائحة تفوق عيوبه. هذا الإصدار قد يؤدي إلى تفعيل جزء مهم من القانون، مثل ذلك المتعلق بانتهاكات الملكية العقارية، وما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر في انتهاكات أخرى قد تكون قوانين العفو قد منعت مساءلة مرتكبيها جنائيًا. فضلًا عن هذا، فإنه قد يؤدي إلى إعادة موضوع العدالة الانتقالية إلى دائرة اهتمام صناع السياسات والرأي العام، وقد يقود إلى خطوات أخرى تنتهي بوضع قانون جديد أفضل للعدالة الانتقالية.